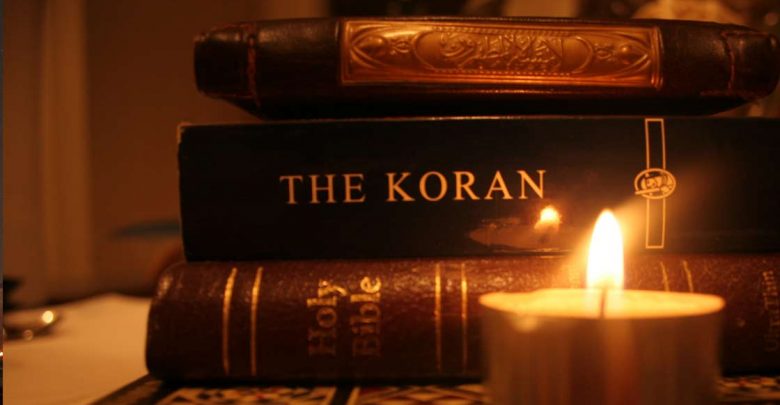
مقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة الــــســلام على جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم(لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.)[1] أما بعد:
فلما كان الإسلام خاتم الرسالات الداعية إلى التوحيد وعبادة الله، فقد كان وسيكون كتابه الكريم مهيمنا ومصدقا لما جاء في الرسالات السابقة، مصدقا؛ أي مؤكدا ما ورد في الكتب السالفة في صورتها الأولى التي لم يلحقها تغيير ولا تبديل، أو ما بقي منها سالما بعد التحريف والتبديل، ومهيمنا؛ إذ الطبيعي أن يكون اللاحق مضيفا للسابق أمورا وأحكاما جديدة، وقد جاءت دعوة الرسل بعضها يكمل بعضا، حتى جاءت الرسالة المحمدية الخاتمة في نسق متكامل، وفلسفة شاملة، تصلح للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان.
لقد جاء القرآن الكريم بوحدة بنائية صالحة لكل زمان ومكان، ولم يكن خادما لفترة زمنية دون أخرى، كما أنه لم يتحكم به التاريخ ولا الأحداث والخرافات والأساطير والشوائب، فالنص القرآني يحمي نفسه بنفسه من لدن حكيم خبير، (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.)[2] لذلك بقي النص القرآني في إطار فلسفته العامة، على عكس ما نجده في نصوص التوراة التي لم تحافظ على وحدتها البنائية، وبفقدانها لهذه الوحدة تعددت النصوص في محاولة من أصحابها دمج نصوص متعددة في فقرة واحدة مليئة بالمتناقضات مما يسهل على القارئ أن يعرف أنها محرفة مزورة، تدخلت فيها أيادي بشرية لونتها بحسب المصالح والرغبات، ونفسه الأمر حصل مع الأناجيل وشروحها من تحريف وتزوير إذ لم يعد يمكن تحديد مفهوم معين أو قضية معينة داخل هذه النصوص، وكثيرا ما يجد القارئ أن هذه النصوص عبارة عن تاريخ لأحداث واقعة معهم بعيدة كل البعد عن الوحي السماوي. لذلك كان للقرآن الكريم الفضل الكبير في تفعيل النصوص المجمدة في الكتب المقدسة، ليخرج بذلك المشترك الديني من كتبهم، والقرآن الكريم رغم تقريره التحريف الذي لحف بهذه الكتب إلا أنه يدعو في كثير من آياته إلى محاورة ومجادلة أصحابها، لذلك وجب على المتصدي لمثل هذه المحاورات والمناظرات أن يتسلح بالعلم الشرعي، وأن يحيط علما بكل الأديان، حتى تكون له الغلبة، وهذا هدف علم مقارنة الأديان.
أولا: مقارنة على مستوى بعض القضايا العقدية
إن المقارنة بين بعض القضايا، تبين لنا كيف يعتقد الآخر بها، وكيف ينظر إليها، وما موقف القرآن العظيم منها، وهذا هو الدور الذي تقوم به قصص الأنبياء ضمن منهج القرآن في إطاره العقدي، الذي يفتح أمام الإنسان صفحة تمثل بداية احتدام المعركة الطويلة بين المنعوم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالون.
1 – الألوهية:
إن الناظر في العهد القديم أو التوراة المنحول سيصدم كما سيصاب بالهلع والذهول، لما يصفون به المولى عز وجل من أوصاف خبيثة- تعالى الله عنها علوا كبيرا- كيف وقد حرفوا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وتركزت جهودهم على وضع كتاب سموه “التوراة”، ليخدم مصالحهم وأهدافهم الآنية والمآلية، وقد جاء القرآن مبينا هذا التحريف الذي ألحقوه بكتابهم، قال تعالى: (يحرفون الكلم عن مواضعه)[3] وقال (فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)[4] فبنو اسرائيل وصفوا الله بالغضب والحزن والغيرة والخوف والعجز، ففي خضم كلامهم عن قصة خلق آدم، قالوا بأنه مخلوق على صورة الله وشبهه، وأنه ابن الله، لذلك فهم بنوه وأحباؤه ومصطفوه. جاء في سفر التكوين: “وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا… فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه.”[5] في حين نجد أن التوراة المنحول- الحياة اليونانية لآدم وحواء- لم يتطرق للحديث عن خلق آدم، أما القرآن الكريم فلم يشر لهذا التشابه بين الله وعبده آدم ولو في آية واحدة.
وصفوا الله عز وجل بعدم المعرفة والقصور عن العلم، جاء في سفر التكوين أن الله لم يعرف بأن آدم أكل من شجرة المعرفة التي نهاه عن الأكل منها إلا عندما اختبأ منه آدم، وكان الرب حسب زعمهم يمشي في الجنة حتى فوجئ بأن آدم أكل من الشجرة” … من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي أعطتني من الشجرة فأكلت”.[6] خاف الرب حسب زعمهم من أن يخلد آدم ويكون مثله عارفا للخير والشر لذلك غضب الرب وبدأ في لعن حواء والحية وآدم والأرض وأخرجهم من الجنة وأنزلهم إلى الأرض وجعل حراسا على باب الجنة حتى لا يدخلها منهم أحد، فهذه أوصاف لا تليق حتى بإنسان فكيف يصفون بها الله جل شأنه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، و”المسلم يرفض كل قول ينسب لله تجسيدا أو تشبيها أو حلولا في أشياء وما في ذلك من أوهام وضلالات، كما يرفض كل حديث يصور الله وقد طرقت به عواطف الإنسان وانفاعالاته وضعفه. فكل ذلك باطل الأباطيل”[7] فالقرآن يصف الله بالتنزه والكمال والعلم والمعرفة. قال تعالى: ( إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون).[8]
2 – العصمة:
إن الأنبياء والرسل عند أهل الكتاب، شأنهم شأن جميع البشر يخطئون ويرتكبون جميع المعاصي والفواحش؛ يزنون، يشربون الخمر، يكذبون، وهذا الأمر لا نستغربه إذا ما عرفنا أنهم قد تجرؤوا على الله جل جلاله ووصفوه بأوصاف دنيئة حقيرة ، فكيف يسلم الأنبياء من هذه الأوصاف؟ وحتى أنبياؤهم الذين يؤمنون بهم لم يسلموا من ذلك، نذكر بعضا من الأمثلة الخطيرة على ذلك. مثلا: ادعاؤهم بأن ابراهيم تاجر في زوجته، وأن لوطا زنى بابنتيه بعدما شرب الخمر، وأنجب منهما نسلا نتج عنه أقوام العمونين والمؤابين، وأن داوود زنى بزوجته أوريا، كما أن هارون يسر مسألة الشرك بصناعته العجل، وأن سليمان كفر ببنائه للهيكل… لم يسلم كذلك سيدنا آدم من هذه الاتهامات التي تمس نبوته، ذكروا أنه أخطأ و”عصى ربه، وورث الجنس البشري كله خطيئته إذ خالف هو وزوجته أمر ربه ومولاه وسيده، لأكلهما من شجرة المعرفة، لذلك أخرجهما ربهما من الجنة وأنزلهما هو وزوجته حواء إلى أرض الدنيا.”[9] سفر التكوين: الإصحاح 3. بل الأدهى من ذلك أنهم اتهموه بأخذ خليلة من الشيطان اسمها ليليت، وأنه عاشرها وأنجبت له أبناء وبنات يسميهم اليهود أبناء وبنات الناس، وأنهم هم نسله المخطئ المتجبر، وفي المقابل اتخذت زوجته حواء خليلا من الشياطين وأنجبت منه أيضا أبناء وبنات الناس. جاء في سفر التكوين: “وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا أن بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر، وتكون أيامه مئة وعشرين سنة، كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولادا هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر دَوُوا اسم.”[10] لم يسلم من هذه الأوصاف إلا أبناء شيت الذين اعتبروهم أبناء الله، وما عداهم فهم أبناء وبنات الشياطين.
أما الإسلام فهو ينفي هذه الصفات القبيحة عن الأنبياء جميعهم، قال تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)[11] فالأنبياء كما جاء في غير ما آية من القرآن أنهم عليهم السلام معصومون من الخطأ كبيره وصغيره، فهم عباده المصطفون الذين لا يجترحون الكبائر. وقد نهى الله جل شأنه عن أذية الأنبياء وتجريحهم في قوله تعالى: ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا).[12] فاتهامات أهل الكتاب للأنبياء كثيرة لا يتقبلها العقل ولا الفطرة، كما وصفوه سبحانه بالندم؛ وذلك أن الله حسب ادعائهم ندم عن خلقه للإنسان، وتأسف على ذلك. جاء في سفر التكوين: “.. حزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته – الإنسان مع بهائم وذبابات وطيور السماء. لأنني حزنت أنني عملتهم”.[13] كما وصفوه ـ سبحانه وتعالى عن وصفهم ـ بالعجز والضعف. جاء في سفر التكوين: “بقي يعقوب وحده وسارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه… وقال اطلقني لأنه طلع الفجر، فقال (يعقوب) لا أطلقك إن لم تباركني. فقال ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت، فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيب بنفسي”[14] والله جل جلاله يلغي هذه الترهات في قوله سبحانه : (وما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز).[15]
3 – الغيبيات:
إن الإسلام دعا إلى الإيمان بعالم الغيب كما دعا إلى الإيمان بعالم الشهادة، حينما دعا إلى الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، فهذه أمور غيبية غير ملموسة، يؤمن بها المسلم بالفطرة وبالأمر القرآني، فلا يجادل ولا يناقش في هذا الأمر، على عكس أهل الكتاب الذين يجعلون لله شريكا تارة، ويجعلونه أبناً تارة أخرى، ويصفونه كما سبق بأوصاف لا تليق بجلاله سبحانه.
إن العهد القديم لم يشر في سفر التكوين إلى أمر الملائكة حينما تكلم عن خلق آدم، في حين نجد القرآن فصل في هذا الأمر، فبين أن الله أخبر ملائكته بأمر خلق آدم، قال تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة).[16]
أما التوراة المنحول وإن لم تتكلم عن أمر الملائكة حينما أخبرهم الله بخلق آدم، إلا أنها تكلمت عنهم في قصة آدم وحواء في حياتهما في الجنة وخروجهما منها، وفي أمر صعود آدم مأتمه وتسمي رئيسهم ميخائيل.
كما أن العهد القديم لم يشر إلى اليوم الآخر، أما التوراة المنحول فقد أشار إلى ذلك في الإصحاح3 عبارة 2 “فقال الله: لقد قلت لك، أنك من تراب وإلى التراب تعود.. وبالمقابل فإنني أعدك بالبعث فسأبعثك عند البعث من جميع النوع البشري تسلك” والتوراة المنحول تكلم عن الموت والبعث، وكذلك القرآن الكريم تكلم عن البعث والنشور والحساب في غير ما آية.
ثانياً: أبعاد القصة
إن لهذه النصوص لها أبعاد عديدة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 – بعد العبرة:
إن الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها السامع، وإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس، والقصة القرآنية تمثل هذا الدور أقوى تمثيل، وتصوره في أبلغ صوره، لكن عندما نطلع على نصوص العهد القديم والتوراة المنحول نجد أن هذه النصوص تركز على السرد القصصي، وتشتغل على مجموعة من الجزئيات دون أن تبين العبرة من ذلك، في حين نجد القرآن العظيم يركز على العبرة من القصص القرآني أكثر من الأحداث، فهو يأتي بالقصة مجملة ولا يتحدث عن التفاصيل، لأن الهدف منها هو أن يُخرج القارئ منها العظة والموعظة، وأن يأخذ منها ما يصلح به عمله حتى لا يقع فيما وقع فيه أعداء الأنبياء والرسل، ويحق عليه ما حق عليهم من عذاب وخسران، والأمر المهم هنا هو الوقوف عند خبر القرآن فيما جاء من القصص والأخبار، وعدم الخوض في تفاصيلها إلا إذا دلَّ عليها دليل صحيح وصريح، خاصة إذا كانت تلك التفاصيل لا ينبني عليها حكم، ولا يترتب عليها شرع.
إن القارئ لقصة آدم عليه السلام في العهد القديم أو التوراة المنحول لا يخرج إلا بأمور تاريخية سردية لأحداث جزئية، أما القرآن الكريم فالقارئ يعلم علم اليقين أن الخارج عن أمر الله، المتكبر على أوامره، يكون مآله الخسران والنار، ومن يمتثل لأوامره هو من أهل الجنة والفوز في الدارين. وهذا يستشف من قوله تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين)[17]، وليس هذا وحسب؛ فكل حرف وكل كلمة وكل آية إلا وتعطي العبر والمواعظ التي لا تعد ولا تحصى، إما أمر أو نهي أو تبيين للجزاء الدنيوي والأخروي للمتكبر.
2 – البعد الأسطوري والعنصري
إن الناظر في العهد القديم والتوراة المنحول يظهر له جليا ذلك البعد الخرافي الأسطوري والعنصري، ذلك أن هذه الكتب أصابها التحريف إثر التحولات من نقل إلى نقل، ومن ترجمة إلى أخرى، إضافة إلى أن هذه النصوص كان يتخللها تراث شعبي لا سند له إلا الذاكرة والنقل، وما ينقل لابد أن يزاد فيه وينقص حسب الظروف التاريخية المعاشة والمصالح المستهدفة.
إن نصوص الكتب المقدسة مليئة بالمتناقضات، فتارة ينسبون أنفسهم إلى الله، وأنهم نسله وهو أبوهم، وتارة أنهم نسل آدم وحواء في نقائه وطهره، وأنه مخلوق على صورة الله وشبهه، وأنه روحه وجزء من روح الله وذاته، جاء في سفر التثنية: “سبع شعوب أكثر وأعظم منك ودفعه الرب أمامك فإنك تُحْرِمُهُم… لا تقطع معهم عهدا ولا تشفق عليهم، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار الرب لتكون له شعبا، أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض، مباركا تكون فوق جميع الشعوب وتأكل جميع الشعوب الذين الرب إلهم يدفع عليك لا تشفق عيناك عليهم..”[18] فهذا النص يبين البعد العنصري في تفكيرهم، وحاشاه سبحانه أن يدعو إلى هذا العدوان وهو الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، ولا نجد مثل هذه النصوص في القرآن الكريم، بل على العكس فالقرآن يدعو إلى التعارف والتواصل والحوار والتعايش والتدافع وحسن المعاملة والمجادلة بالحسنى، قال تعالى: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)[19] حتى الحوار والمدافعة والنقاش معهم أطره القرآن الكريم في إطار من الأخلاق السامية، التي تنفي وجود العنف والعنصرية في الإسلام كما يدعون.
إن توظيف هذه الأبعاد في التوراة إنما هو لأغراض دينية يحاول بنو اسرائيل تمريرها، أعلاها التمكين لبني اسرائيل، فهم يحرصون دائما أن يكونوا من سلالة الأنبياء… لذلك بدلوا وحرفوا الكلم عن مواضعه خدمة لمآربهم. لكن القرآن جاء ليبين ذلك… قال تعالى: (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق).[20]
خاتمة:
إن هذا النوع من الدراسة المقارنة ليس الهدف منه إبراز التحريف والتزوير الحاصل في التوراة المنحول والعهد القديم فقط، لكن الهدف والمقصد أيضا؛ إبراز المشترك بين الديانات لخلق أرضية للتواصل مع الآخر، وفتح حوار موضوعي معه، ولذلك لابد في هذا الحقل المعرفي أن يتمسك الباحثون في بحوثهم بالمنهجية العلمية التي يفرضها علم تاريخ الأديان أو علم مقارنة الأديان، كما أنه لابد أن يسلكوا مسلك المدارسة، لتلمس جوهر الحوار المتمثل في معرفة الآخر والابتعاد عن المفهومات الخاطئة، مما يتيح للباحث والقارئ فرصة التعرف على الآخر والتحاور معه، لا لأن الغرب يدعو إلى الحوار وفتح باب التواصل، بل لأن هذا الأمر أصَّل له القرآن الذي دعا ــ منذ نزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ــ إلى الحوار والتعايش والتدافع مع الآخر، ولم يأت هذا الأمر لصبغة ظرفية أو سياسية.. ولكنها دعوة قرآنية سرمدية.
إن الحوار وإبراز المشترك هي مطالب قرآنية، يجب أن تأخذ طابعها الديني، ولا ينبغي أن تؤثر فيها المنظومة الثقافية المبنية على آراء الآخر، فهذا الآخر وإن فتح باب الحوار فإنه لا تتحكم فيه إلا قوانين وضعية قابلة للتغيير والتبديل حسب الظروف والمصالح، في حين أن الحوار الإسلامي تؤطره فلسفة قرآنية خالدة إلى الأبد.
الهوامش: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[2] – سورة الحجر، الآية: 9.
[3] – سورة النساء، الآية: 46.
[4] – سورة البقرة، الآية: 79.
[5] – سفر التكوين، الإصحاح: 1.
[6] – سفر التكوين، الإصحاح: 3.
[7]– أحمد محمد الوهاب، الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاختلاف والاتفاق، مكتبة وهبة، ص : 49.
[8] – سورة البقرة، الآية: 32.
[9] – محمد عزت الطهطاوي، الميزان في مقارنة الأديان حقائق ووثائق، ص: 34
[10] – سفر التكوين، الإصحاح: 6.
[11] – سورة الأنعام، الآية: 90.
[12] – سورة الأحزاب، الآية: 57.
[13] – سفر التكوين، الإصحاح: 6، العبارة 7.
[14] – سفر التكوين، الإصحاح:30 – 32 – 34.
[15] – سورة الحج: الآية: 84.
[16] – سورة البقرة، الآية: 30.
[17] – سورة الأعراف، الآيات: 11- 12- 13.
[18] – سفر التثنية، الإصحاح: 7.
[19] – سورة العنكبوت، الآية: 46.
[20] – سورة المائدة، الآية: 18.
لائحة المصادر والمراجع:
-القرآن الكريم.
-الكتاب المقدس: دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، الطبعة 2005.
-التوراة: كتاب ما بين العهدين 3 التوراة المنحول- الحياة اليونانية لآدم وحواء- تحقيق دانييل برتاران، مخطوطات قمران- البحر الميت، دار الطليعة الجديدة.
– أحمد شلبي، مقارنة الأديان(1) اليهودية، مصر، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة 8، 1988.
– محمد علي البار، أباطل التوراة والعهد القديم (2) الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم، دراسة مقارنة، بيروت، الدار الشامية، الطبعة 1، 1410ه/1990م.
– محمد عزت الطهطاوي، الميزان في مقارنة الأديان: حقائق ووثائق، بيروت، الدار الشامية، الطبعة 1، 1413ه/ 1993م.





التعليقات