
مقدمة
تهدف رسالة سبينوزا (رسالة في اللاهوت والسياسة) إلى تحديد علاقة بين الدين والسياسة، من خلال عدد من الإشكاليات المتعلقة بهيمنة الدين على السياسة، والتي تحاول تبرير إرادة سياسية لا علاقة لها بالنص الديني، وذلك عن طريق عقلنة مناهج دراسة الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية. ولذلك رفض سبينوزا في رسالته –موضوع هذه القراءة- القراءات اللاهوتية وانتقدها انتقادا لاذعا، لاعتمادها على أحكام جاهزة ومسبقة، وتشبثها بمبدأ التصديق والتسليم الذي تستغله الفئات الكنسية والسياسية على السواء للهيمنة على أفئدة العامة دون أي مراجعة نقدية.
ولهذا يعتبر سبينوزا في عصره، من أكثر الفلاسفة جرأة رغم ما جره عليه هذا المؤلف من الويل والنقد اللاذع، لكون هذه الرسالة عالجت إشكالية الدين والمعجزة والوحي وتاريخ الشعب اليهودي، بطريقة فلسفية مجردة من الاعتبارات الإيمانية والاعتقادية، وفق منهج محدد لاكتشاف معاني النصوص المقدسة وهو المنهج الهندسي[1]، والذي يقوم بدراسة الظواهر الطبيعية والبشرية بعيدا عن ادعاءات النخبة المستغلة للدين، والتي انتقدت سبينوزا اليهودي -الذي لم تشفع له ديانته أمام شعبه-، حيث اعتبروا الرجل قد “صنع رسالته في جهنم وساعده في ذلك الشيطان”[2].
لكن سبينوزا على العكس من ذلك –كما سنرى-، فهو يدعو في منهجه إلى ثورة فكرية عن طريق التعامل مع متون النصوص المقدسة وفق منهج يعتمد على العقل والملاحظة ثم التجريح التاريخي، فمسألة تفسير النصوص المقدسة مثلا ليست حكرا على تراث بعينه، بل يمكن إسقاطها وإحلال مادة أخرى محلها، مع الإبقاء على نفس المنهج، كإسقاط التراث اليهودي وإحلال محله التراث المسيحي أو الإسلامي كما يقول اسبينوزا.
وعليه، فإن رسالة سبينوزا شكلت ثورة على الأوضاع الثقافية والسياسية في عصره بل وفي كل عصر، وإن كان مسبوقا من قبل فلاسفة أفذاذ قبله، فما كانت فلسفة الرجل إلا امتدادا للفكر الديكارتي الذي يعتمد على المنهج العلمي والرياضي في تحليل الظواهر الكونية، وإن كان سبينوزا كما يقول حنفي: “هو الديكارتي الوحيد الذي استطاع أن يطبق المنهج الديكارتي تطبيقا جذريا في المجالات التي استبعدها ديكارت من منهجه، خاصة في مجال الدين”[3].
ولأن فصول رسالة اسبينوزا كثيرة وأكبر من أن يحاط بها كلها، وتكاد تكون متداخلة فيما بينها، فإننا ارتأينا في هذه القراءة تدقيق النظر في الموضوع ومحاولة لم فصلول هذه الرسالة بعضها ببعض، نتناول من خلالها البناء العام لنظرية سبينوزا في الدين والسياسة، والدين والفلسفة، من خلال ما يتعلق بفلسفة الدين وعلم الاجتماع الديني.
فمن هو باروخ سبينوزا هذا؟ وما أهم مؤلفاته؟ وما أهمية رسالته هذه في مجال فلسفة الدين وعلم الاجتماع الديني؟ وما السياق التاريخي الذي أفرزها؟ وما هي أهم موضوعاتها؛ إن في المجال اللاهوتي، أو في مجال علاقة الفلسفة بالدين أو في المجال السياسي؟
أولاً: باروخ سبينوزا، حياته وأهم مؤلفاته
- حياة الرجل
ولد باروخ سبينوزا بأمستردام عام 1632م وهو من فئة تسمى المارانو MARRANOS كان ولده ميخائيل تاجرا ميسور الحال وله شركة تجارية لا بأس بها، تم إعداده في الصغر ليكون رجل دين، حيث تلقى تعليمه الأولي في مدرسة التلمود، تأثر بالنزعة الثورية لأستاذه (فان دن انده Van den ende) و(أورييل داكوستا Uriel Dacosta ) الذي حاول تفسير الكتاب المقدس تفسيرا تاريخيا وأنكر خلود النفس، وكان رد الطائفة اليهودية قاسيا، مما أدى به إلى الانتحار، ثم بعد ذلك انتقل سبينوزا إلى المدرسة الاكليريكية فتعلم لغات عديدة منها الاسبانية والبرتغالية والعبرية، وقد درس التراث القديم اليوناني واللاتيني والمسيحي كما درس الرياضيات والطبيعيات وشيء من مبادئ الطب، فبدأت ملامح التمرد على العقيدة اليهودية تظهر عليه وهو في الثالثة والعشرين من عمره.
وقد اتخذت هذه الثورة أولا شكل مناقشات متحررة جريئة، ثم تحولت إلى عدم اكتراث بالطقوس والشعائر التي يتبعها المجتمع اليهودي، وقد حاول اليهود رده إلى حظيرة الدين اليهودي، لكنه آثر حرية الفكر فلم تفلح معه محاولات الإغراء المادي والتهديد الإرهابي مما زاد سخط الطائفة اليهودية عليه، فطردوه وعمره في الرابعة والعشرين سنة 1656م، فانتقل خارج أمستردام إلى عدة أماكن ريفية هادئة كرينسبورج ولاهاي، لكنه لم يستسلم لهذا الواقع فقد اتصل بالجمعيات الفكرية والدينية ذات الآراء المتحررة، وكان له دور فعال ومنها “طائفة المجمعين أو المحلفين”[4] “وطائفة المينونية”[5] كما كان لسبينوزا عدة أصدقاء يشاطرونه أفكاره منهم “لودفيج ماير” و”جارج جللس” و”سيمون دي فريس” فانتشر صيته، في هولندا وكل أنحاء أوروبا فتقرب إليه كثير من الحكام، كالأمير الفرنسي “كونديه”والحاكم الهولندي “ياندي فت”، الذي تميز بنزعات تحريرية بعد طرده لأسرة أورانج ذات المذهب الكالفيني سنة 1650م، كما عرض عليه أمير “بافاريا” تدريس الفلسفة في جامعة هيد لبرج لكنه رفض[6].
وبالتالي فإن باروخ لم يكن في حياته ذاك الرجل الزاهد في الحياة، كما أنه لم يكن ذلك المفكر المنعزل الغارق في تأملاته بين جدران أربعة، بل كان محبا للحياة، حريصا على المشاركة في شؤون مجتمعه والتفاعل الإيجابي بها. ولم يكن في ذلك بالطبع مما يتنافى مع رغبته في التفرغ لعمله العلمي بالاعتزال عن الناس من آن لآخر لفترات طويلة.
وفي إحدى فترات عزلته هذه، اشتد عليه المرض الذي كان يعانيه لفترة طويلة، وهو علة في الرئة ربما كان سرطانا أو التهابا حادا، يرجح أن سببه هو استنشاقه المستمر لغبار زجاج العدسات التي كان يصقلها، ثم حلت نهايته فجأة وبهدوء يومه الأحد 21 فبراير 1677م.
- مؤلفاته:
نشر سبينوزا أثناء حياته كتابين فقط:
- الأول: صدره باسمه، وموسوم بـ: “مبادئ الفلسفة الديكارتية” ومُلحقه الصادر بعنوان “أفكار ميتافيزيقية” وقد نشر هذا الكتاب في أمستردام عام 1663م، و يمثل بحق عرضا لفلسفة ديكارت وفقا للمنهج الهندسي المفضل لدى باروخ سبينوزا.
- والثاني: لم يذكر فيه اسبينوزا اسمه، حيث أشار الغلاف إلى أن الكتاب طبع في هامبورج، وهو بعنوان: “البحث اللاهوتي السياسي” وقد نشر في أمستردام سنة 1670م، فالكتاب تضمن بحثا مفصلا لموضوع حرية الفكر في الموضوعات الدينية وضرورة فصل الدين عن الدولة كما يرفض سبينوزا من خلاله ويحمل بشدة على كل حُكم سياسي يدعي أنه يستمد سلطته من مصدر إلهي. والواضح من موضوعات هذا الكتاب أنها هي التي جعلت سبينوزا لا يذكر اسمه على غلاف الكتاب خشية فضح أمره وهذا هو ما حدث بالفعل، وبعد وفاته قام تلاميذه بنشر مجموعة من المؤلفات المختلفة سنة 1677م وذكروا اسمه بالحروف الأولى: B.D . ويحتوي المجلد على كل المؤلفات التالية:
* الأخلاق.
*البحث السياسي.
*إصلاح العقل.
*بحث موجز في الله والإنسان وسعادته.
*الرسائل.
*رسالة للغوي العبري.
ثانياً: رسالة سبينوزا؛ السياق والأهمية
- سياق الرسالة:
لا يجهل أحد ما لقيه الإنسان الأوربي من قمع العقل وطمسه، إذ كانت الكنيسة (الكاتوليكية) في نظر المسيحيين المتدينين صورة للإخلاص والصفاء والأمانة، فأصبحت الكنيسة وعلى رأسها البابوية سيدة أوربا التي لا تنازع، إذ كان البابا يعتبر نفسه مستمدا للسلطة من الإله، وبالتالي فهو المسؤول عن تصرفات الإنسان المسيحي، ولا يحد من قوته إلا الحدود الإلهية، فهو من جهة واهب كل الدرجات داخل الكنيسة، والمحدد للقيم داخل المجتمع من جهة ثانية، بل الحارس والمدافع عن القوانين الدولية من جهة ثالثة، لذلك عرف قرن ما قبل اسبينوزا (قرن العقلانية)، بقرن النهضة والإصلاحات الدينية والسياسية مع “جون هوس(1369-1415)” و”مارتن لوثر(1483-1546)” و”جون كالفن(1564-1509)” في الإصلاح الديني، ومع “نيكولا ميكيافيلي(1469-1527)” و”جون بودان (1530-1596)” وغيرهما في الإصلاح السياسي، أي المرحلة التي بدأت فيها أوربا تبتلع العالم على حد تعبير “فيرناند بروديل”[7]. فجاء عصر اسبينوزا كأحد أهم فلاسفة العقل والتنوير الذين عاشوا في القرن السابع عشر، فوضع منهجا فلسفيا مغايرا للمنهج الذي كان سائدا آنذاك في الكنائس الكاثوليكية والكالفينية، وهو منهج عقلاني صارم لا يقبل إلا بالبراهين والأدلة والوضوح، بين من خلاله رؤيته للكون والعالم والإنسان، لكن تطبيقه للمنهج الشكي على الكتب المقدسة هو ما أثار حفيظة رجال الدين الكاثوليكيين والكاليفيين عليه أكثر من غيره، حيث أثبت الكثير من التناقضات والتلفيقات وأنكر الكثير من المعجزات الواردة في الكتب المقدسة، والتي تتناقض في رأيه مع نظام الكون.
ولقد شرح باروخ سبينوزا أسباب كتابته “للرسالة” وأجملها في ثلاثة أسباب[8]:
- الأول: الأحكام المسبقة لرجال الدين، لأن هذه الأحكام المسبقة لنفسها هي التي تعيق الناس بالخصوص عن توجيه أدهانهم نحو الفلسفة، ويرى أنه من المفيد تعرية هذه الأحكام وتجريد الأذهان منها.
- الثاني: الفكرة التي ترسخت عند العامة والتي تستمر في اتهامه بالإلحاد، فقد رأى نفسه مرغما على محاربتها قدر المستطاع.
- الثالث: حرية التفلسف والتعبير عن رأينا، فهو يريد إقرار ذلك بكل الوسائل، فسلطة الوعاظ الدينيين المفرطة واندفاعهم يميلان إلى نفيها.
فالرسالة إذن، مشروع مهمته الأساسية تعرية الأحكام المسبقة التي هيمنت على رجال الدين، وكذلك الدفاع عن حرية التفلسف والاعتقاد المهددتين بالتطرف الديني والسياسي المحافظ، ولهذا كان هذا المشروع رابطا بين الدين والسياسة بالأساس.
ولم تكن الانتقادات التي وجهتها الأوساط الكاثوليكية هي الانتقادات الوحيدة التي وجهت للرسالة، بل حتى الأوساط الديكارتية بمنهجها القائم على الشك لم تستطيع بجرأتها أن تتجاوز الحدود في مناقشتها للدين، سواء الكتاب المقدس أو الكنيسة، أو العقائد، أو التاريخ المقدس، لكون ديكارت صديقا لرجال الدين، إذ اعتبروه دعامة للدين، ونصرة لعقائده، رغم الاختلاف معهم في الوسيلة للوصول إلى الغاية مؤقتا، فالغاية واحدة مشتركة بينهم وبينه، وهي إثبات وجود الله، وخلق العالم، ثم خلود النفس، أي القضايا الدينية الثلاث في كل فكر ديني تقليدي، بيد أن فيلسوف العقل الذي لا يقبل شيئا على أنه حقا ما لم يكن كذلك، لكن الحقيقة هي أن الوحي والعقيدة يتجاوزان العقل، ويقتصر دور العقل على التنوير فقط .
فالمصلحة العامة ضد رجال الدين وضد الحكم القائم والأمانة الفكرية، البحث العلمي والموقف الشريف، أجدى على الدولة وعلى سلامتها وأمنها من النفاق الفكري والتشويه العلمي والتملق للسلطة، والسعي لها.
ولعل استمرار المنهجية السبينوزية هي التي أدت إلى استمرار القرارات النقدية للنصوص بكافة أشكالها، ومن هنا تولدت الكثير من المناهج والمدارس والفلسفات من أهمها، الفينومنولوجيا والهرمونيطقا… ومن هنا، اعتبر سبينوزا مثالا للفيلسوف الحر الذي قاوم التسلط بشتى أنواعه. الشيء الذي جعل هيجل يتغنى بفلسفته حين قال عنها:
“إما أن يكون المرء سبينوزيا أو لا يكون فيلسوفا على الإطلاق”.
ثالثاً: أهمية الرسالة:
تكمن أهمية رسالة اسبينوزا في كونها تعتبر ثورة حقيقية فكرية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية في عصره وبعد عصره، لتمتد فلسفة ديكارت وتنزل مع التلميذ اسبينوزا، فما كانت فلسفة الرجل إلا امتدادا للفكر الديكارتي الذي يعتمد على المنهج العلمي والرياضي في تحليل الظواهر الكونية، كما أشرنا في المقدمة، فهو الديكارتي الوحيد الذي استطاع أن يطبق المنهج الديكارتي تطبيقا جذريا في المجالات التي استبعدها ديكارت من منهجه، خاصة في مجال الدين (الكتب المقدسة، الكنيسة، العقيدة، والتاريخ المقدس،…)، إضافة إلى أن اسبينوزا في رسالته طبق منهج الأفكار الواضحة والمتميزة في ميدان الدين والعقائد، كما يرفض الرجل في رسالته تفسير الآيات الواضحة تفسيرا خياليا حسب هوى المفسر، وهذا ما سنقف عنده في محورنا اللاحق، فهو ينتهج منهج النقد التاريخي للكتاب المقدس، يفصل به بين الآيات الصحيحة والآيات المكذوبة أو المشكوك فيها[9].
وبنفس المنهج انتقد اسبينوزا في رسالته هاته السياسة، ليكون سابقا على كانط وهيجل، في هذا اللون من التفكير السياسي من أجل تحديد الصلة بين الفكر والواقع، أو بين الدين والدولة، بحيث يعتبر الديكارتي الوحيد –يقول حنفي دائما- الذي طبق منهج ديكارت في السياسة، فدرس الرجل أنظمة الحكم، وقارن بينها، ونقد الأنظمة التسلطية القائمة على حكم الفرد المطلق، وانتهى إلى أن النظام الديموقراطي هو أكثر النظم اتفاقا مع العقل والطبيعة، علما أن ديكارت استثنى في الكوجيطو النظم السياسية والتشريعات الوطنية، وعادات البلد، أي أنه أخرج الجانب الاجتماعي كله من الشك وقصره على الفكر[10]، يقول ديكارت: “ينبغي قبل كل شيء أن نتمسك بقاعدة تعصمنا من الزلل وهي أن ما أوحاه الله هو اليقين الذي لا يعادله يقين آخر… الأولى هي أن أطيع قوانين بلدي وعاداته، وأن أبقى على الدين الذي أكرمني الله به، ونشأني عليه منذ الطفولة”[11].
وعليه فإن اسبينوزا ورسالته كانت تهدف إلى تأصيل الدين، وإخضاع الكتاب المقدس للنقد التاريخي، في الوقت الذي كانت مهمة أستاذه ديكارت: تبرير الدين، بحيث لم يأت بما يعارض قضاياه، بل جاء مؤيدا لأهم قضاياه: كوجود الله، وخلق العالم، وخلود النفس… أما اسبينوزا -يقول حنفي- فقد غلب المصلحة العامة ضد الدين ورجاله، وضد نظم الحكم القائمة، ويشير إلى أن الأمانة الفكرية، والبحث العلمي، والموقف الشريف، أجدى على الدولة وعلى سلامتها وأمنها من النفاق الفكري، والتشويه العلمي، والتملق للسلطة، والسعي لها[12].
رابعاً: أهم موضوعات رسالة اسبينوزا
الطبعة التي اعتمدنا في هذه الدراسة هي التي نشرتها دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، عام 2005، والتي قدمها وترجمها الدكتور حسن حنفي، الذي اعتمد بدوره على ترجمتين فرنسيتين، الأولى “لمادلين فرنسيس” و”روبير ميزراحي” بالتشارك عام 1953، والثانية ل”جارنييه Garnier” عام 1968 كما راجعها الدكتور فؤاد زكريا، وهي كما تقدم “رسالة في اللاهوت والسياسة” للفيلسوف الهولندي باروخ اسبينوزا، الذي ديل عنوان الرسالة بنص توضيحي لمضامينها وموضوعاتها إلى حد كبير، يقول سبينوزا: “وفيها تتم البرهنة على أن حرية التفلسف لا تمثل خطرا على التقوى أو على السلام في الدولة، بل إن القضاء عليها يؤدي إلى ضياع السلام والتقوى ذاتها في آن واحد”[13]. ثم بنص من رسالة يوحنا، كأنه يحاول طمأنة أنصار “كالفن” وأتباع “روما” للتوفيق بين جميع الطوائف الدينية، وعليه فإن الرسالة لها هدفان:
- الأول: إثبات أن حرية الفكر (العقل) لا تُمثل خطرا على الإيمان
- والثاني: إثبات أن حرية الفكر لا تُمثل خطرا على سلامة الدولة (السياسة)
فإذا غاب التفكير (العقل) ظهرت الخرافة، وإذا سادت الخرافة ضاع العقل، والخرافة تظهر بإرجاع الظواهر الطبيعية إلى علل أولى، أو إلى قوى وهمية، أو إلى أفعال خيالية، أو إلى موجودات غيبية مثل الجن والشياطين والأرواح الخبيثة أو الطيبة، وإن خرجت هذه الظواهر عن المألوف بدت وكأنها معجزات وخوارق يمكن معرفتها، يقول اسبينوزا: “لو استطاع الناس تنظيم شؤون حياتهم وفقا لخطة مرسومة، أو كان الحظ مواتيا لهم على الدوام، لما وقعوا فريسة للخرافة… ولما كانوا يتقلبون بلا هوادة بين الخوف والرجاء لحرصهم الشديد على النعم الزائلة التي يجلبها القدر، فإنهم يميلون دائما أشد الميل إلى التصديق الساذج”[14].
وعلى كل فإن الكتاب يحتوي بين دفتيه على ما يقارب الأربع مائة وخمسون صفحة، المائة الأولى كلها تقديم للكتاب استهل بها حسن حنفي ترجمته فأجاد وأفاد، كأنه يعيد التأليف، وقد صرح بذلك صراحة وجملة عندما قال: “إن اختيار نصوص بعينها للترجمة في حد ذاته تأليف غير مباشر”[15]. أما رسالة اسبينوزا فتقع في مقدمة (عشر صفحات: من 109 إلى 118) وعشرون فصلا، من خلال مضامين هذه الفصول ومحتوياتها يمكن تقسيم محاور اهتمام الرسالة إلى جانبين أساسيين وهما:
- الجانب اللاهوتي: ويبتدئ من الفصل الأول حتى نهاية الفصل الثالث عشر:
(من ص:119 إلى ص: 366)
- الجانب السياسي: ويبتدئ من الفصل السادس عشر إلى الفصل العشرين:
(من ص:337 إلى ص: 445)
وبين هذا وذاك جانب يهمنا كثيرا، ويتعلق الأمر بعلاقة الدين بالفلسفة أو اللاهوت بالعقل.
- الجانب اللاهوتي في رسالة اسبينوزا
ويمكن تقسيم فصول هذا الجانب إلى ثلاثة محاور أساسية:
- الأول، يتعلق بالنبوة عموما: ونجده في الفصول الثلاثة الأولى، وقد بدأ سبينوزا بدراسة النبوة لأنها الموضوع الذي يتناوله الباحث عندما يريد دراسة الوحي، بحيث يتم كشف الوحي من خلال النبوة. ويعرف سبينوزا النبوة على أنها “المعرفة اليقينية التي يوحي الله بها إلى البشر عن شيء ما. و النبي هو المفسر لما أوحى الله به لأمثاله من الناس الذين لا يقدرون على الحصول على المعرفة اليقينية“[16]. كأن النبوة هنا تتطابق تماماً مع المعرفة الفطرية لأن ما تعرفه بالنور الفطري يعتمد على معرفة الله وحدها وعلى أوامره الفطرية، وتشمل النبوة مستويين عند اسبينوزا: الجانب الرأسي، وهو صلة النبوة بمصدر الوحي، والمستوى الأفقي، الذي يتحدد بالتاريخ، وتحديدا بصلة النبوة بالرواة وانتقالها من رواية إلى أخرى، حتى يتم التدوين، وانتقال المصحف من يد إلى أخرى حتى يتم التقنين، وقد درس اسبينوزا هذا الأخير عن طريق النقد التاريخي للكتب المقدسة. رى سبينوزا بأن النبوة لا تزيد في علم النبي شيئاً، بل تتركهم و أفكارهم السابقة. فلقد جهل الأنبياء أشياء كثيرة، حيث أن كثير من أقوالهم في تناقض صريح مع العلم، فقد ظن أن الشمس تدور حول الأرض لأنه لم يكن عالماً في الفلك. يقول سبينوزا: “… والأفضل أن أقول صراحة أن يشوع قد جهل علة بقاء الضوء، وأنه اعتقد مع جمهور الحاضرين بدوران الشمس حول الأرض، وبأنها توقفت في هذا اليوم بعض الوقت…”[17] كذلك ظن أن تناقص الظل يرجع إلى تناقص الشمس. ولكن جهل الأنبياء بالأمور النظرية لا يعني جهلهم بالإحسان وبقواعد السلوك البشري في الحياة، لذا فإن علينا تصديقهم فيما يتعلق بغاية الوحي وجوهره، وهو العدل و الإحسان. ويطرح سبينوزا سؤالا آخر وهو هل هناك صلة بين المعرفة النبوية و المعرفة الطبيعية؟ فيرى أن لا فرق بين الاثنين حيث أن المعرفة النبوية هي معرفة يقينية، و المعرفة الطبيعية أيضاً معرفة يقينية. لكن المعرفة النبوية خاصة بالأنبياء وحدهم، أما المعرفة الطبيعية فهي عامة للبشر جميعاً، و يوجد فرقين اثنين يمكن تميزهما، الأول هو أن المعرفة النبوية تستعمل الصور الخيالية من أجل التأثير على النفوس، في حين أن المعرفة الطبيعية تدرك الحقائق ذاتها دون تخيل، والثاني أن المعرفة الطبيعية غايتها الحق، في حين أن المعرفة النبوية غايتها الخير. قبل أن ينتقد اسبينوزا الآراء المتعارضة فيما بينها عند الأنبياء، ويؤكد على أنه “لا جدوى على الاطلاق من أن نلتمس لديهم معرفة بالأشياء الطبيعية والروحية، فلسنا ملزمين بالإيمان بالأنبياء إلا فيما يتعلق بغاية الوحي وجوهره، أما فيما عدا ذلك فيستطيع كل فرد أن يؤمن بما يشاء بحرية تامة”[18]
- والثاني يتعلق بالقانون الإلهي في وضع الشعائر، والمعجزات الإلهية: وهو المتضمن في الفصل الرابع والخامس والسادس، فالشريعة هي القانون الإلهي الذي تمت صياغته في قانون إنساني، والوحي لم ينزل فكرا فقط، بل نزل أيضا نظاما للكون، كما يقول حسن حنفي: وكما نقول نحن المسلمون: “الدين عقيدة وشريعة”، وقد كان الدين اليهودي عند موسى شريعة أكثر منه عقيدة، وكان الدين المسيحي عقيدة أكثر منه شريعة[19]. فالقانون عند اسبينوزا يتوقف على ضرورة طبيعية، عندما يصدر بالضرورة من طبيعة الشيء ذاته أو من تعريفه، وإما عن طريق قرار إنساني عندما يفرضه البشر على أنفسهم وعلى الآخرين ليجعلوا الحياة أكثر أمنا وأكثر يسرا[20]. في إشارة منه إلى القانون الخاص والذي يتعلق بالإنسان وأخيه الإنسان، والذي هو: “عبارة عن قاعدة للحياة يفرضها الانسان على نفسه، أو على الآخرين من أجل غاية”[21] في إشارة منه للتفرقة بين القانون الإلهي الذي يتطلع ويصبوا إلى الخير الأقصى وهو معرفة الله وحبه، والقانون الإنساني الذي يتطلع ويصبوا إلى الأمن والسلام والاستقرار داخل الدولة[22]. فلما كان حب الله هو السعادة القصوى والغاية الأخيرة للأفعال الإنسانية، فإن من يحب الله يكون هو المطيع حقا للقانون الإلهي، لا عن خوف أو رجاء، بل عن معرفة بالله، يقول الفيلسوف المتصوف في هذا المقام: “وإذن فالدرس الذي تُعلمنا إياه فكرة الله هو أن الله خيرنا الأقصى، وبعبارة أخرى فإن معرفة الله وحبه هما الغاية القصوى التي ينبغي أن تتجه إليها جميع أفعالنا”[23] ومما ذكر سابقا خلص اسبينوزا إلى أن شريعة موسى يمكن اعتبارها قانونا إلهيا، رغم أنها لم تكن شاملة، فبالنظر إلى طبيعة هذا القانون الإلهي، فإن الرجل يلحظ ما يلي[24]:
- كونه قانونا شاملا يعم الناس جميعا، ومستنبط من الطبيعة الإنسانية.
- كونه لا يتطلب أن نصدق بروايات تاريخية، أيا كان مضمونها.
- كونه لا يقتضي إقامة الشعائر والطقوس، أي أن هذا القانون الإلهي الطبيعي لا يتطلب أفعالا يتعدى تبريرها حدود الفهم الإنساني.
- كونه (القانون الإلهي) يعرف بنفسه، أي معرفة الله وحبه باعتبارنا موجودات حرة حقا.
وأما المعجزات والتي يعتبر العامة في نظر اسبينوزا أن “قدرة الله وعنايته تظهران بأوضح صورة ممكنة إذا حدثت في الطبيعة،… فهم يعتقدون أن أوضح برهان على وجود الله هو الخروج الظاهر على نظام الطبيعة”[25]. بحيث ترى أن تفسير هذه الظواهر الخارقة بعللها الطبيعية المباشرة إنكار لوجود الله، فإذا عمل الله توقفت الطبيعة، وإذا توقفت الطبيعة عمل الله، كأن هناك قوتان عند العامة: قوة الله وقوة الطبيعة التي خلقها الله وتخضع لقوته، ويعتقد باروخ أن أصل هذه الفكرة يعود إلى اليهود القدماء.
وعموما فإن اسبينوزا هنا يركز على أنه لا يحدث شيء يناقض الطبيعة، فالطبيعة تحتفظ بنظام أزلي لا يتغير، كما أنه لا يمكن معرفة ماهية الله أو وجوده من خلال المعجزات، كما لا يمكن معرفة العناية الإلهية أيضاً، ولكن يمكن معرفتها كلها عن طريق قانون الطبيعة الثابت الذي لا يتغير.
- وأما الثالث، فيتعلق بنقد الكتاب المقدس عموما: وهو الذي يتضمنه الفصل السابع من الكتاب إلى الخامس عشر منه، فبعد أن وضع اسبينوزا الكتاب المقدس موضع البحث، وانتهى إلى كثير من النتائج النقدية الصحيحة، والتي أيدها التاريخ بعد ذلك في القرون التالية لعصر اسبينوزا، فإن اسبينوزا وضع تفرقة بين الوحي المكتوب والوحي المطبوع، فالأول يقول اسبينوزا، قابل للتغيير والتبديل، وخاضع للتحريف والتزييف، وهو الوحي الذي دافع عنه الصدوقيون في إيمانهم بالشريعة المكتوبة في الألواح، وهو الوحي موضوع النقد التاريخي، لا الوحي المطبوع[26] وبالتالي فالنقد التاريخي لا يمس جوهر الوحي ومعناه وفحواه، بل الصورة اللفظية والشكل التاريخي. وإن كانت الأمور يقول اسبينوزا “قد وصلت إلى حد لم يعد الناس معه يطيقون أن يصحح أحد آرائهم المتعلقة بالدين، فأصبحوا يدافعون بعناد عن الأحكام المسبقة المتميزة التي يتمسكون بها باسم الدين، فأصبحوا يدافعون بعناد عن الأحكام المسبقة، ولم يعد للعقل أي مكان إلا عند عدد قليل نسبيا”[27] ثم بدأ اسبينوزا وبطريقة منظمة بنقد هذه الأحكام المسبقة بدءا بمن قاموا بتدوين الأسفار الخمسة، من داخل التوراة نفسه باستحضاره شواهد كاشفة وفاضحة لمن يدعي أن موسى هو من كتبها، وبأسباب مماثلة برهن اسبينوزا على أن سفر يشوع ليس من وضع يشوع نفسه، وكذا الحال بالنسبة لأسفار القضاة وراعوت وصموئيل والملوك… بل إنه يقول اسبينوزا “إذا نظرنا الآن إلى تسلسل هذه الأسفار كلها وإلى محتواها، رأينا بسهولة أن الذي كتبها مؤرخ واحد أراد أن يروي تاريخ اليهود القديم منذ نشأتهم الأولى حتى هدم المدينة لأول مرة”[28] ويرى أن هذا المؤرخ هو عزرا بتحفظ ولأسباب وجيهة، وقد جمع النصوص من مصادر كثيرة ولم يحاول التوفيق بينها ما جعلها تأتي مضطربة ومتعارضة. ثم انتقل اسبينوزا في فصل آخر إلى نقد العهد الجديد، وركز على الحواريين الذين كتبوا العهد الجديد باعتبارهم رجال دين، وليسوا بأنبياء، وكيف أنهم اختاروا أكثر الطرق ملاءمة في الإقناع، ويرى أنه من الممكن جدا الاستغناء عن كثير من كتاباتهم دون أن ينقص ذلك من الوحي شيئا، فهناك أربعة أناجيل، والله لم يقصد أن يقص حياة المسيح أربع مرات، وأن يوجد في أحد الأناجيل ما لا يوجد في الإنجيل الآخر، وألا تتفق هذه الأناجيل الأربعة إلا على النذر اليسير الذي يمكن الاستغناء عنه، دون أن يؤثر في فهم الإنجيل.
وأما منهج تفسير وتأويل الكتاب المقدس فقد شكل تصورا جديدا وأصيلا لمعنى النص المقدس عند اسبينوزا، فالتفسير هو المسألة العامة التي تضم كثيرا من المسائل النقدية والعلمية على السواء، كما أن هذا المفهوم ليس حكرا على فرد أو سلطة بعينها، بل لكل فرد الحرية المطلقة في أن يفسر الكتاب كما يشاء وبحسب فهمه وأن يؤمن بالعقائد كما يريد فالله لا يحرم على فرد حرية البحث ولا يمنعه حقه في التفكير والفهم والتفسير، وبناء على ذلك يرفض سبينوزا سلطة الكنيسة في التفسير، وما تدعيه من حق في تفسير الكتاب المقدس مع العلم أنه لا يتهمها بالكفر، فالكنسية كيفت الكتاب حسب عقائدها الخاصة، ومنعت الآخرين من حرية البحث والتفكير واتهامهم بمعاداة الله بكونهم يختلفون معها في الآراء والمعتقدات وهذا ما أدى بسبينوزا إلى رفضه لمنعها هؤلاء بسبب اختلافهم معها، مما أدى إلى كثرة التفسيرات القائمة على الهوى والخرافة والأوهام والتي تؤخذ على أنها كلام الله ويجبر الآخرون على الاعتقاد بها، لكي لا تظهر أخطاء تفسيراتهم للعامة، مما ينتج عنه احتقار العقل.
لذلك، يقترح سبينوزا منهجا لتفسير النصوص الدينية، وهو منهج مطابق لمنهج تفسر الظواهر الطبيعية، يقول: “أنه (منهج( لا يختلف في شيء عن المنهج الذي نتبعه في تفسير الطبيعة، بل يتفق معه في جميع جوانبه[29]“ إنه إذن مشروع يقوم على جعل المنهج السليم القائم على العقل والذهن يحل محل المنهج المبتور القائم على الانفعالات، وهو المنهج العقلي الذي يخضع كل شيء للتحليل وللدراسة، فكل ما يمكننا قوله من الأشياء عن الكتاب المقدس، وكل ما يمكننا أن نكونه عن معرفة عن فقراته وموضوعاته إنما هي معرفة تطابق المعرفة التي نكونها عن الأشياء الطبيعية، أي أن الكتاب المقدس عندما يكون موضوع تحليل ودراسة، يكون مثل أي شيء من أشياء الطبيعة، وبالتالي يجب التعامل معه كما تعامل مع الظواهر الطبيعية ذاتها، فدراسة سبينوزا للكتاب لا تقوم على مسبقات كوضعية الكتاب المقدس تقع خارج إطار العقل، أو خارج اللغة أو خارج كل شيء بل إن دراسته تقف على المعنى الحقيقي والمطابق لفقرات النص عن طريق النور الطبيعي كما يقول سبينوزا “هناك من يظنون أن النور الطبيعي لا يقدر على تفسير الكتاب، وأنه لا بد لذلك من وجود نور يفوق الطبيعة[30]“ لأجل ذلك، اعتقد البعض أن قراءة النصوص تستدعي قوة تفوق النور الطبيعي لفك ألغازها وحل أسرارها على الرغم من أن أصحاب هذا الادعاء حسب سبينوزا لا يقدمون أي تفسير يتجاوز النور
وهكذا يمكن أن نخلص إلى أن منهج تفسير الكتاب المقدس، هو الطريق اليقيني الوحيد لمعرفة المعنى الحقيقي للنص المقدس رغم ما نعانيه من صعوبات لغوية وتاريخية، تمنعنا من معرفة الأشياء التي لا يمكن إدراكها. وبالتالي فالقاعدة الأساس تتمثل في حذف كل ما يناقض العقل أو الطبيعة لأنه زيادة من الراوي لإثارة النفوس، وتحريك الخيال.
خامسًأ: علاقة العقل باللاهوت أو علاقة الفلسفة بالدين
قبل أن ينتقل باروخ اسبينوزا إلى الجانب السياسي من رسالته، تناول في الفصلين الرابع عشر والخامس عشر آخر مشاكل الجانب اللاهوتي، وهي الصلة بين العقل واللاهوت أي الفلسفة والدين، وهي –يقول حنفي- المشكلة التقليدية في فلسفات الأديان والتفكير الديني بوجه عام، بحيث يرى أنه لا توجد أية صلة بين العقل والإيمان (الفلسفة والدين)، أو كما يقول هو: بين العقل والفلسفة من ناحية، وبين الإيمان واللاهوت من ناحية أخرى، إذ يقوم كل علم (الفلسفة واللاهوت) على مبادئ مختلفة اختلافا جذريا على المبادئ التي يقوم عليها العلم الآخر، فغاية الفلسفة عند اسبينوزا الحقيقة، وغاية اللاهوت الطاعة[31]. وفي هذا الصدد يقول: “وهذا أمر لا يمكن أن يجهله من يعلم غاية كل من هاذين المبحثين وأساسه، إذ أنهما متعارضان أشد التعارض، فغاية الفلسفة هي الحق وحده، وغاية الإيمان كما بينا من قبل هي الطاعة والتقوى وحدهما”[32] كما ذهب إلى أن “الأسس التي تقوم عليها الفلسفة هي الأفكار المشتركة، وهذه يجب أن تستخلص من الطبيعة وحدها. أما الإيمان فأسسه هي التاريخ وفقه اللغة، وهي أسس ينبغي أن تستمد من الكتاب والوحي وحدهما”[33] ومن ناحية أخرى فإن أسلوب الفلسفة هو العقل الذي يدرك الأشياء على ما هي عليه، وأسلوب الإيمان هو التخيل الذي يبغي التأثير في النفوس، ولذلك يترك الإيمان الحرية لكل فرد في أن يتفلسف كما يشاء، حتى في موضوع العقائد.
وقد ناقش اسبينوزا بإسهاب في الفصل الخامس عشر، كما في الرابع عشر مسألة يعتبرها زائفة يعرض لها الباحثون لكونهم لا يفرقون بين الفلسفة واللاهوت، ومفادها ما إذا كان الكتاب ينبغي أن يكون خادما للعقل؟ أم ما إذا كان العقل خادما للكتاب؟ أي هل يجب إخضاع العقل للكتاب أم إخضاع معنى الكتاب للعقل؟ فالأول موقف القطعيين (الكتاب تابع للعقل)، وأما الثاني فموقف الشكاك (العقل تابع للكتاب) الذين ينكرون يقين العقل، بحيث يرى اسبينوزا أن كلتا النظريتين خاطئتين أشد الخطأ، فكلتاهما تجعلان العقل أو الكتاب فاسدا بالضرورة.
ويرى فيلسوف العقل (اسبينوزا) أن أول من ادعى وجوب إخضاع الكتاب للعقل هو “موسى ابن ميمون”[34]، الذي هو صراحة منهج اسبينوزا نفسه دون أن يتبناه بالعبارة، مع أنه يوحي برفضه لهذا المنهج، مع أنه يقبله ضمنا، ورسالته هاته شاهدة على ما ندعيه، خاصة في فصلها السابع، والموسوم ب “تفسير الكتاب”.
وأما الاتجاه الثاني فيرى اسبينوزا أن “يهوذا البكار”[35] هو الذي يمثل الاتجاه الذي يرى ضرورة نزول العقل على حكم الكتاب وخضوعه له كلية، والذي يرى أنه “لا ينبغي تفسير أي فقرة من الكتاب تفسيرا مجازيا (كما يفعل البعض) بدعوى أن المعنى الحرفي مناقض للعقل”[36] بحجة أن المعنى الحرفي يعارض العقل، في حين أنه يجوز التأويل إذا ما عارض النص الكتاب نفسه، أي إذا ما عارض العقائد التي يدعوا إليها الكتاب، خاصة وأنه -يقول البكار- لن نجد في الكتاب عقيدة تعارض أخرى تعارضا مباشرا، بل نجد فقط تعارضا في النتائج المترتبة عليها، ولهذا السبب فقط يجب تفسير الفقرات تفسيرا مجازيا، كالنصوص التي تشير إلى تعدد الآلهة أو توحي بذلك، في حين أن الكتاب كله يشير إلى وحدانية الله. أو التي تشير إلى أن الله لا جسم له، ومن ثم فنحن ملزمون بناء على النص لا على العقل، بالاعتقاد بأن الله لا جسم له، فنحن ملزمون بناء على سلطة هذا النص وحده بأن نفسر تفسيرا مجازيا كل الفقرات التي تنسب إلى الله يدين وقدمين[37].
وبهذا ينتهي اسبينوزا برفض الاتجاهين معا لكون اللاهوت ليس خادما للعقل، وأن العقل ليس خادما للاهوت “بل إن لكل منهما مملكته الخاصة التي لا تتعارض مع الأخرى على الإطلاق، للعقل مملكة الحقيقة والحكمة، كما قلنا من قبل، وللاهوت مملكة التقوى والخضوع”[38] وخلص إلى أنه لا يقلل في هذا الفصل بين اللاهوت والعقل من منفعة الكتاب المقدس، كأن الرجل يغلب العقل على النقل، حين يقول: “إذ لا يستطيع النور الفطري (ويقصد العقل) أن يبين لنا أن الطاعة (ويقصد الدين) هي وحدها طريق الخلاص”[39] كأنه يريد أن يقول بأن الكتاب المقدس في متناول الجميع يستطيعون الوصول إليه وطاعته، في حين أن فئة قليلة من البشر (يقصد الفلاسفة) هم من يستطيع الوصول إلى حالة الفضيلة عن طريق العقل.
سادساً: الجانب السياسي في رسالة اسبينوزا
يحضرني في هذا المبحث اسم محمد باقر الصدر كأول من أطلق على باروخ اسبينوزا اسم الفيلسوف الصوفي[40] في كتابه “اقتصادنا”، وقال عنه بأنه قال “بحق الشعب في انتقاد السلطة” عكس توماس هوبز الذي قال في كتابه “lévitâmes Le أو التنين” عكس ذلك، عندما قال: “انزعوا الطاعة، وبالتالي وئام الشعب من أي نوع من أنواع الدول، وسترون كيف سيتبدد هذا المجتمع، وسترون أن أولئك الذين يدعون بأنهم يصلحون، أنهم يفسدون… فالإنسان ذئب للإنسان، لم تخلق فيه روح الاجتماع، والحاجة تدفعه إلى أن يبحث عن أصدقاء لا من أجل المصلحة لأن المصلحة الذاتية هي قوة محرك السلوك”.
وعكس هوبز انتقل اسبينوزا في الفصول الخمس الأخيرة من رسالته من الفصل بين الفلسفة واللاهوت، بإثبات أن اللاهوت يترك لكل فرد حرية التفلسف إلى أن يتساءل إلى أي حد يمكن المضي في ممارسة حرية الفكر والقول في أفضل الدول؟ وكيف يكون المواطنون أحرارا في الدولة؟ وما الحق الطبيعي لكل إنسان؟ وما حق الدولة؟
وقد وضح اسبينوزا قصده بالحق الطبيعي أو التنظيم الطبيعي بكونه “مجرد القواعد التي تتميز بها طبيعة كل فرد، وهي القواعد التي ندرك بها أن كل موجود يتحدد وجوده وسلوكه حتميا على نحو معين”[41] هو الحق الذي يكتسبه الكائن الإنساني وفقاً لطبيعته. فلكل كائن حي طبيعة، فمن طبيعة السمك أن يعيش في الماء ويأكل الكبير منه الصغير، وبذلك فالماء هو الحق الطبيعي الخاص بالسمك، وما ينطبق على الأسماك ينطبق على كل كائن حي، ومعنى هذا أن الحق الطبيعي للكائن الحر هو حقه في حفظ بقائه واستمراره في الحياة بتمكنه من وضع يده على كل ما يحفظ هذه الحياة ويديمها. والكائن الإنساني أيضاً له حق طبيعي في المحافظة على وجوده، وبذلك يكون هو السلوك وفقاً لقوانين طبيعته الخاصة. هذا الحق المطلق في الحياة وحفظ البقاء يشترك فيه الإنسان مع الحيوان، ولذلك فالحق الطبيعي المطلق أو البيولوجي يعطي للإنسان الحق في أن يفعل ما يشاء ويعتبر من يقف في طريقه عدواً له، وهو في ذلك يسلك وفقاً للرغبة والشهوة. لكن هذا ما يؤدي إلى حدوث صراع بين الناس لا ينتهي. وهذا الحق الطبيعي المطلق يحدث له تهذيباً وتعديلاً، ذلك لأن الإنسان مجبر على العيش في جماعة، وتكون هذه الجماعة هي الأخرى ممتلكة لحق طبيعي في البقاء، ولا يمكن أن يستمر بقاؤها إذا كان لكل فرد فيها الحق المطلق في أن يفعل ما يشاء وفقاً لرغباته وشهواته، لأن هذا ينتهي إلى الصراع الذي يهدد وجود الجماعة ذاتها. وهكذا ينتقل سبينوزا من الحق الطبيعي المطلق إلى الحق الطبيعي الاجتماعي والعقلاني، الذي يفرض على الناس العيش وفقاً للعقل بمراعاة مصالح الآخرين وحقوقهم، يقول: “ولكي يعيش الناس في أمان وعلى افضل نحو ممكن، كان لزاما عليهم أن يسعوا إلى التوحد في نظام واحد، وكان من نتيجة ذلك أن الحق الذي كان لدى كل منهم، بحكم الطبيعة، أصبح ينتمي إلى الجماعة، ولم تعد تتحكم فيه قوته او شهوته، بل قوة الجميع وإرادتهم”[42].
ويقوم التنظيم الاجتماعي هذا على تعاهد الأفراد المكونين له على أن يتخلَّوْا عن أهدافهم وشهواتهم ويضعوا المصلحة العامة فوق مصالحهم الشخصية، ويتجسد هذا التعاهد في صورة عقد اجتماعي، يفوض فيه المجتمع أموره العامة إلى شخص يمثله و ينوب عنه، ويضع في يده سلطة تسيير الأمور العامة. وبالتالي يكون هذا العقد بين طرفين: الجمهور الذي يعين شخصاً منه لتولي شؤون المصلحة العامة، والشخص الذي تم اختياره ليكون نائباً عن الجمهور، وهذا هو الحاكم الذي يستمد سلطانه من الجمهور ومن المجتمع، والذي يستمد شرعيته من كونه ممثلاً للشعب وقائماً على المصلحة العامة.
ولأن السلطة السياسية تنشأ من رغبة الجماعة في الحفاظ على ذاتها وعلى مصلحتها العامة ولأنها تتأسس في تخلي الأفراد عن حقهم المطلق في الدفاع عن أنفسهم للسلطة، فإن من واجب الأفراد إطاعة هذه السلطة والخضوع لها تماماً، طالما أن هذه السلطة تستمد شرعيتها من المجتمع وطالما أنها تمثله وتدير شؤون مصالحهم العامة، ويذهب سبينوزا إلى أن الفرد في خضوعه لأوامر السلطة لا يكون عبداً لها، ذلك لأن العبودية هي أن يتبع المرء أهواءه وشهواته، أما الخضوع للسلطة الشرعية ولما تمثله من مصلحة عامة فليس عبودية بل هو طاعة للعقل وأوامره العقلانية. ويكون الفرد الملتزم بقوانين مجتمعه مواطناً طالما ظل قابلاً للسلطة التي يمثلها الحاكم والتي تستمد شرعيتها من هذا المجتمع نفسه. إلا أن تكون مخالفة لأمر الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يقول: “وقد يسألني سائل: ما العمل إذا ما أعطت السلطة العليا أمرا مناقضا للدين والطاعة التي وعدنا بها الله تنفيذا للعهد الصريح؟ هل يجب الخضوع للأمر الإلهي أم للأمر البشري؟… سأكتفي بأن أقول هنا بأنه عليه أن يطيع الله قبل كل شيء عندما يكون لدينا وحي يقيني لا شك فيه”[43] فهو يرى أن الغرض من إقامة نظام سياسي ليس السيادة أو القهر أو إخضاع الشعب لطاعة فرد آخر، بل التحرر من الخوف بحيث يعيش كل فرد في سلام و طمأنينة، أي المحافظة على الحق الطبيعي في الحياة وفي السلوك وفي العمل دون إلحاق الضرر بالغير.
وبعد أن يشرح سبينوزا نظريته في مقومات الدولة وكيف أنها قائمة على حفظ الحق الطبيعي الاجتماعي عن طريق عقد اجتماعي، يشرع في توضيح الحق المدني، أو القانون المدني الخاص. ويعني القانون المدني حق المواطن في أن يحفظ حياته ويحميها في إطار السلطة السياسية التي خضع لها. فعندما تخلى الأفراد عن حقهم المطلق في حماية أنفسهم للسلطة أصبحت هذه السلطة ملزمة بحمايتهم، كما أصبح المواطنون ملزمين بكل ما تفرضه هذه السلطة من قوانين، طالما كانت هذه السلطة شرعية وتمثل المصلحة العامة. “وما يجري على الحقوق المدنية يجري كذلك على القانون المتعلق بالشؤون الدينية، والذي ينبغي أن يكونوا هم أيضا المفسرين له والمدافعين عنه”[44].
وفي الختام وجه اسبينوزا رسالة واضحة لمثيري الشغب، الذين يسعون في دولة حرة القضاء على حرية الرأي مؤكدا على أنه[45]:
- يستحيل سلب الأفراد حريتهم في التعبير عما يعتقدون.
- يستطيع الأفراد الاحتفاظ بحريتهم دون تهديد ما لم يسعوا إلى تغيير قوانين الدولة وهيبتها.
- يستطيع الفرد أن يتمتع بهذه الحرية دون أن يكون في ذلك خطر على سلامة الدولة.
- لا يجلب التمتع بهذه الحرية أي خطر على التقوى.
- لا فائدة من القوانين الموضوعة بشأن المسائل النظرية العقلية.
- حرية الفرد يضمن حق السلطة العليا واستقرارها.
وهكذا نصل مع سبينوزا إلى أن النص الديني لا يجب أن ننظر إليه بتلك النظرة الساذجة أو بذلك الإيمان الاعتقادي المسبق. دون تحليل نابع من النص وفق المنهج الهندسي الذي يتم الاحتكام إليه، فهو منهج علمي بالمقام الأول يقوم على عرض الأفكار في شكل قضايا، وبعد ذلك يتم البرهنة عليها لاستخلاص النتائج. ومع ذلك فإن فلسفة سبينوزا كانت أشبه باختراع سابق لأوانه فهي لم تحدث أثرا كبير في العصر الذي ظهرت فيه، لأن ذلك العصر لم يكن على استعداد بعد لتقبل مثل هذه الأفكار الثورية، فوجهت الرسالة بنقد شديد من طرف الأوساط الكالفينية والكاثوليكية التي لم يكن هجومها غيرة على الدين بقدر ما كان خوفا على مصالحهم ومكانتهم داخل مجتمعاتهم، لكن فلسفة سبينوزا في تقديرنا كانت بحق نهضة تاريخية في النقد الديني والفلسفي، والتي كان لها وقع وأثر كبير في عصر العقل وعصر النهضة وعصر العلم في أوربا، بحيث قال عنه هيجل “إما أن يكون المرء سبينوزيا أو لا يكون فيلسوفا على الإطلاق”.
الهوامش:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]– المنهج الهندسي هو منهج استخدمه سبينوزا في دراسته للكتاب المقدس يقوم على عرض القضايا والبرهنة عليها واستخلاص النتائج أي أنه يقيم فكره على أساس رياضي في المقام الأول. انظر: فؤاد زكرياء، سبينوزا، بيروت، دار للنشر والطباعة، 2،1981،ص، 38.
[2] – أحمد العلمي، مجلة مقدمات، مقال في أسس الحداثة، سبينوزا وتأويل النصوص المقدسة، الدار البيضاء، عدد 31، 2004، ص 48.
[3] باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، تقديم حسن حنفي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 2005، ص:09
[4]طائفة مركز بلدة ريسنبورج وقد ظهرت سنة 1619 م من أهم شخصياتها الأخوان فاندركوده مذهبهما “إلغاء سلطة رجال الدين في مسألة معرفة الله إذ أن الروح الإلهية كامنة في الجميع، ولكل نفس الحق فيها والتحدث عنها”.
[5]طائفة مؤسسها سيمون ظهرت منيو ظهرت في أواخر القرن 16 مذهبها “الدعوة لحرية الدين ورفض سيطرة الكالفية واللوثرية عليه فالعقائد الثابتة والطقوس والمظاهر الخارجية للعبادة ليست ذات جدوى لكن الأهم هو طهارة القلب والخير وحب الجار”.
[6]– فؤاد زكرياء، سبينوزا، ص 19.
[7] F. BRAUDEL , Civilisation matérielle, economie et capitalisme, paris, éd. 1979, t.1 ; p :402
[8] أحمد العلمي، مجلة مقدمات مقال في أسس الحداثة: سبينوزا وتأويل النصوص المقدسة، عدد 31، 2004، ص 49.
[9] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:09-11
[10] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:11
[11] Descartes, Discours de la méthode, p :141
[12] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:12
[13] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:107.
[14] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:109
[15] نفسه، ص:05
[16] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:119
[17] نفسه، ص: 152
[18] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:162
[19] نفسه، ص:162
[20] نفسه، ص:183.
[21] نفسه، ص: 184-185.
[22] نفسه، ص:185
[23] نفسه، ص: 186
[24] باروخ اسبينوزا، م.س، ص187-189
[25] نفسه، ص: 213
[26] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:73
[27] نفسه، ص: 257
[28] نفسه، ص: 267
[29] – باروخ اسبينوزا، م.س، ص 242.
[30] باروخ اسبينوزا، م.س، ص 258.
[31] نفسه، ص: 82
[32] باروخ اسبينوزا، م.س، ص: 353
[33] نفسه، ص:353
[34] يرى حسن حنفي أن موقف ابن ميمون يشبه موقف المعتزلة والفلاسفة من جواز التأويل واعتبار العقل أساسا للنقل، يستطيع الوصول إلى معرفة الله وإثبات وجوده ووحدانيته.
[35] يرى حسن حنفي أن موقف البكار يشبه موقف الحشوية في تراثنا القديم، أو موقف أهل الظاهر، فقد قالت الحشوية بأن طريق معرفة وجود الله هو السمع لا العقل، وقد اعتبرها ابن رشد في فصل المقال فرقة ضالة، ولذلك فهم يؤمنون بالنص الحرفي كما هو دون تأويل، وكذا الظاهريون الذين يتمسكون بظواهر النصوص وإلى إنكار الرأي والقياس والتعليل.
[36] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:356
[37] نفسه، ص: 356
[38] نفسه، ص:363
[39] نفسه، ص: 365
[40] لتطابق نظريته في وحدة الوجود أي تلاحم الطبيعة والإله في كيان واحد في تراثنا الصوفي ،فهذه النظرية موجودة وحية في ما يطلق عليها بمسألة الحلول ولعل من يدرس مؤلفات الصوفية (كالحلاج مثلا)يجد بصمات النظرية السبينوزية .
[41] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:367
[42] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:370
[43] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:383
[44] باروخ اسبينوزا، م.س، ص:421.
[45] نفسه، ص:443-444.



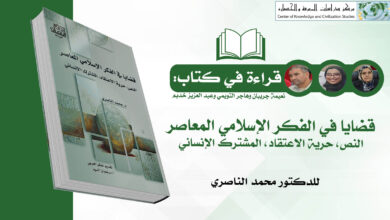

التعليقات