الإسلام: البديل الحضاري

الإسلام: البديل الحضاري.
قراءة في كتاب: “الإسلام في الألفية الثالثة: ديانة في صعود”[1]
لمراد هوفمان[2].
لا مبالغة في القول بأن البشرية اليوم، تواجه مأزقها، تشهد على ذلك المعضلات المتفاقمة، والإخفاقات المتلاحقة، والانهيارات المفاجئة التي تعج بها الساحة الإنسانية.
والأزمة هي عالمية بقدر ما هي شاملة، إذ تضرب في غير مكان، وعلى غير صعيد من صعد العمل الحضاري والنشاط البشري، ليصبح من تكرار القول الكلام على المأزق الوجودي الراهن كما تشير إليه عناوين المؤلفات والمقالات التي تتناول الوضع البشري، مثل الصدمة، الرعب، النهاية، السقوط، الانحلال، العدمية، ومن اللافت للنظر أن أكثر المؤلفات الفكرية والفلسفية التي صدرت في فرنسا (عام 2005) قد جرى إدراجها تحت عنوان : العالم في أزمة[3].
الشعور بالأزمة والتنبيه على خطورتها ذلك ما سبق وأن عبر عنه المؤتمر العالمي للأديان المنعقد بشيكاغو عام 1993م في بيانه الختامي إذ جاء في ديباجته:
“عالمنا اليوم في محنة وكرب بلغا من الإلحاح مبلغا عظيما يدفعنا إلى سبر غورهما وعوارضهما بسبب عمق هذا الألم المستشري.
السلام يفوتنا … والكوكب يتعرض للدمار … الجيران يعيشون في خوف … هناك غربة بين النساء والرجال والأطفال يموتون.
إنه أمر بغيض ! …”[4] .
عمق الأزمة وتعدد مظاهرها أدى “إلى طرح أخطر سؤال نعرفه في العصر الحديث: الإنسانية إلى أين؟.
بعبارة أدق: هل هي سائرة نحو الفناء أو نحو البقـاء؟ … نحو الشقـاء أو نحو الهنـاء؟ … نحو عنصرية متشددة أو نحو عالمية متحررة؟… نحو صدام بربري أو نحو حوار حضاري؟ نحو سحق حقوق الإنسان أو نحو الحفاظ على هذه الحقوق؟ … نحو تكنولوجيا غاشمة أو تكنولوجيا واعية؟ هل ستسود المعرفة على القوة والمال أم تسود القوة على ما عداها من فعاليات؟[5].
ورغم تعدد صيحات الإنذار وكثرة صفارات التحذير، التي يشترك في إطلاقها رجال الدين والفكر والسياسة والعسكريون وأهل الاقتصاد ورجال الأعمال والصناعة والقانونيون والإعلاميون والمعنيون بالبيئة[6] فالبشرية مازالت تعاني من ترديها الأخلاقي، والأزمة في استفحال وتفاقم مستمرين.
إجمالا “إن هتافات كثيرة من هنا ومن هناك، تنبعث من القلوب الحائرة وترتفع من الحناجر المتعبة … تهتف بمنقذ وتلتف إلى “مخلص” وتتصور لهذا المخلص سمات وملامح معينة تطلبها فيه … وهذه السمات والملامح المعينة لا تنطبق على أحد إلا على الدين الإسلامي”[7].
في هذين السياقين، سياق الكشف عن خطورة المأزق الوجودي الذي يعيشه عالمنا المعاصر، وسياق التأكيد على أحقية الإسلام للانتصاب كأحد الخيارات المتاحة أمام البشرية لإنقاذ مستقبلها، يأتي كتاب: “الإسلام في الألفية الثالثة: ديانة في صعود”. لمؤلفه السفير الألماني مراد هوفمان.
وفي الكتاب، -كما يبدو من عنوانه- نلحظ بعدا مستقبليا، يمثل شهادة حية على قدرة الإسلام في فرض تعاليمه و قيمه كأحد الخيارات الحضارية المساعدة على تجاوز أزمات العالم الراهنة العميقة الجذور والمتعددة المظاهر والخطيرة العواقب.
وواضح أن البعد المستقبلي عند هوفمان ليس وليد هذا الكتاب، وإنا هو قناعة تبلورت عند هوفمان منذ كتابه: “الإسلام كبديل”[8]، والذي يقول في مقدمته: “كان الإسلام إبان الصراع بين العالم الغربي والشيوعية، يستطيع أن يعد نفسه الطريق الثالثة المباينة لهما، أي أنه الخيار الحر المستقل عن كليهما لفهم العالم والتعامل معه عقائديا، أما اليوم فإن الإسلام يطرح نفسه بديلا لكلا النظامين، وذلك لتوفير الحياة على أفضل وجه وتذليل مشكلاتها المستفحلة، خاصة بعد أن عاد العالم من جديد مصطرع كتلتين اثنتين”[9].
ويمضي هوفمان قائلا: “إن الإسلام لا يطرح نفسه بديلا (خيارا) للمجتمعات الغربية بعد الصناعية، إنه بالفعل هو البديل الوحيد”[10].
وقد حاول هوفمان في هذا كتاب “الإسلام كبديل” جاهدا تقديم الأدلة العملية على قدرة الإسلام في الانتصاب حلا للأزمة العالمية الراهنة. وكتاب: “الإسلام في الألفية الثالثة: ديانة في صعود”، مرافعة جديدة منه لتحقيق نفس الغرض، وذلك من خلال محاولته الإجابة عن أسئلة من قبيل:
هل سيستمر انتشار الإسلام في الغرب كما حدث في الثلث الأخير من القرن العشرين؟ هل سيتم هذا بالوسائل السلمية؟ ما النتائج المرتقبة في حالة نجاح العالم الإسلامي في أن ينهض من جديد وبالتالي يكتسب قوة جاذبة في الغرب؟ هل يمكن أن يصبح هذا الدين، وهو نظري وعقائدي بالفعل دينا يسود العالم؟ هل يصبح الإسلام في هذه الحالة العلاج والشفاء الذي سينقذ الغرب من نفسه؟ وهل سيبح الغرب قادرا على الاعتراف بالإسلام كدواء يصلح لشفائه، دواء يساعد الغرب على تخطي أزمته وإنقاذ حضارته؟.
شكلت هذه الأسئلة خلفية الكتاب، والتي جاءت فصوله عبارة عن إجابات عنها. والكتاب في شكله العام، يضم مقدمة وخمسة عشر فصلا.
افتتح هوفمان كتابه بشعار الطبيب”فريدريش ديرنمات”، مفاده: “إنني لا أستطيع إلا أن أقرر -بصفتي طبيبا-، أن الإنسانية غارقة في أزمة رهيبة”. تدليلا من هوفمان على عمق الأزمة التي يعيشها إنسان الحضارة المعاصرة، أزمة تعم العالمين الغربي والشرقي على حد سواء.
وقد رصد هوفمان مظاهر هذه الأزمة في الفصلين الأولين من كتابه، وهم على التوالي: “مفتون الغرب المحير” و”الشرق: المثير للتساؤل”، فأورد أرقاما وصورا لمظاهر الخلل في كلا العالمين.(ص: 19-80).
وعقد الفصل الثالث للغوص في تاريخ العلاقة بين الشرق والغرب ومواجهاتهما؛ العلاقة التي توجهها في نظر هوفمان العقلية التي نتجت عن الحروب الصليبية، وبالتالي فالعلاقة بين الغرب والإسلام على فترات التاريخ المشترك بينهما لم تكن علاقة إيجابية، وهذا ما يفسر عنوان هذا الفصل: “سنوات طويلة من الغضب”. (ص: 81-102).
أما الفصل الرابع، المعنون بـ: “وسائل الإعلام تحت المراقبة”، فقد خصصه هوفمان لإبراز دور وسائل الإعلام الغربية في تأزيم العلاقة بين العالمين الغربي والإسلامي. ملخصا ذلك بترديد مقولة جوته: “لا يسعني إلا أن أتذكر هؤلاء المعارضين الذين إذا ما أرادوا شرا بأحد، فإنهم يشوهونه أولا، ثم يحولونه إلى وحش تجب محاربته”.
وتتحمل وسائل الإعلام –في رأي هوفمان- القدر الأكبر من المسؤولية ليس فقط في أن يكون الإسلام أكثر الديانات المرفوضة والمستنكرة، بل أيضا أن يظل كذلك. ويقول هوفمان -بلغة الواثق، وهو كذلك، بحكم وظيفته السابقة لإدارة المعلومات التابعة لحلف الناتو، والتي شغلها في الفترة ما بين (1978م/1983م)، والتي مكنته من امتلاك نظرة واقعية للإمكانات المختلفة في المجال الإعلامي وما تستطيع أن تقوم به وسائل الإعلام- يقول: “ومما لا يدع مجالا للشك أن عدم التسامح المستمر إزاء كل ما هو إسلامي وبالتالي الإبقاء على كل ما هو سلبي في الذاكرة الجمعية تجاه الإسلام، ما هو إلا عمل من أعمال وسائل الإعلام”. (ص: 105).
وقد أورد هوفمان نماذج عن وسائل إعلامية مكتوبة ومسموعة تنخرط في تشويه صورة الإسلام ووصفه بأنه دين إرهاب وعنف..وترسخ هذه الصورة المشوهة في أذهان الناس بل يزيدونها سوءا. (ص:107-117).
جاءت بقية فصول الكتاب، لرد مجموعة الاتهامات التي ينسبها الغرب إلى الإسلام، وتتعلق هذه الاتهامات في مجملها بالقضايا التالية:
-موقف الإسلام من حقوق الإنسان.
-موقف الإسلام من حقوق المرأة.
-موقف الإسلام من الديمقراطية.
-موقف الإسلام من المساواة.
-موقف الإسلام من حقوق الأقليات غير المسلمة.
ويعتبر هوفمان أن التعامل الإيجابي مع هذه القضايا شرط أساسي يضعه الغرب لتطبيع العلاقات مع الإسلام. وقد حاول هوفمان الرد على الاتهامات الغربية المرتبطة بالقضايا السالفة الذكر، مؤسسا مرافعته، على أرضية معرفية رصينة، مؤكدا أنه لا صحة لما يقال عن عدم قدرة المسلمين على الوفاء بحقوق الإنسان. فالإسلام لم يكتفي بمعرفة الحقوق التقليدية للإنسان منذ أكثر من 1400سنة، ولكنه مارسها ورسخها أكثر مما فعلت مواثيق الغرب. (ص:126).
أما بخصوص موقف الإسلام من الديمقراطية فهوفمان يؤكد أن الإسلام في حد ذاته لا يعادي الديمقراطية، بل على النقيض يتضمن لبنات أساسية لتوطيد أركان ديمقراطية إسلامية، ما على المسلمين إلا العمل على تحقيقها. ولذلك يبدو اتهام المسلمين والإسلام بالعداء الديمقراطي في نظره ضربا من ضروب العنصرية. معتبرا أنه من الخطأ الفادح أن يتوصل المحللون للتاريخ السياسي للإسلام، وليس للإسلام وقواعده، إلى نتيجة مفاده: أن المسلم فيما يخص ممارسة الديمقراطية موصوم بعدم ممارستها بحكم ميلاده.(ص:157-158).
وإذا كان الإسلام مع حقوق الإنسان ولا يعادي الديمقراطية، فمن باب تحصيل حاصل –عند هوفمان- ضمانه حقوق المرأة وتكريمه إياها بالشكل والقدر الذي يحفظ حقوقها الإنسانية ويصون كرامتها الآدمية، عكس ما يدعي المغرضون. لقد اتسمت صورة المرأة في الإسلام بالإيجابية، لأن القرآن لم يلصق بحواء صفة الغواية، مما كان له عظيم الأثر نفسيا في إضفاء الإيجابية على المرأة كما أن القرآن لا يذكر أنه عاقب حواء على غوايتها لآدم، فالقرآن يصف الذنب الذي ارتكبه كل من آدم وحواء على أنه فعل مشترك أدى بأن ينزل كلاهما من الجنة إلى الأرض. كما أن القرآن لا يتضمن ما يشير إلى أن آدم خلق قبل حواء، وأن الأخير خلقت من ضلع من ضلوعه. وتختلف هذه الصورة تماما عن الموروث اليهودي المسيحي، والذي يحمل المرأة ذنوبا شتى، مما أدى إلى أن تدان المرأة حتى تكاد تتساوى مع الشيطان في الفكر المسيحي بدءا ببولس الرسول-حرق الساحرات أعظم الأدلة- وحتى أول العصر الحديث (ص: 172-179).
وإمعانا في التأكيد على عظم المكانة المتميزة التي تتمتع بها المرأة في الإسلام، انبرى هوفمان لتوضيح موقف الإسلام من مجموعة من الأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة يتجه النقد الغربي إليها، من قبيل: تعدد الزوجات، وضع المرأة في الزواج، النصوص الشرعية الخاصة بزي المرأة، حجاب المرأة، والفصل بين الجنسين، سلطة الرجل في طلاق زوجته من طرف واحد، انتقاص حق المرأة في الإرث والشهادة. مؤكدا هوفمان أنها قضايا ليست ذي تأثير ولا ظلم فيها للمرأة ولا تنقص من كرامتها الإنسانية، إذا ما أحسن فهمها الفهم الصحيح. ومن تم فإن الإسلام ليس دينا معاديا للمرأة، وأنه لا يمكن بأي حال أن نتهم القانون الإسلامي بأنه ظالم لأنه يقترب، بل يتطابق مع الطبيعة البشرية دون تسطيح لمفهوم الطبيعة. (ص: 191).
وبالنفس ذاته أكد هوفمان أن الإسلام دين المساواة، ودين الاعتراف بالتعدد والاختلاف، واحترام الأقليات، وأن أحكامه وتشريعاته تمثل النقيض للشوفونية والعنصرية. (ص:193-270).
على طول صفحات الكتاب يبدي هوفمان حماسة في الدفاع عن الإسلام وأحكامه، ويجهد نفسه في رد كل الاتهامات العالقة بها، متسلحا بالتجربة الفريدة للعهدين النبوي والراشد. إلا أن هذه الحماسة سرعان ما تخفت عندما يتعلق الأمر بمسلمي هذا العصر، محملا إياهم فرص تقبل الإسلام. وما يلبث يكرر طلبه للمسلمين بالغرب، بضرورة التجديد والاجتهاد حتى يتمكنوا من إعطاء الدليل حقا وصدقا على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وإنسان. يقول هوفمان: “فأنا لا أريد أن أسكت عن الاتهام الموجه مني إلى المسلمين. فعلى المسلمين أولا أن يقوموا باللحاق بما فاتهم من عملية التنوير والإصلاح الإسلامية، فبدون ذلك تقل فرص الإسلام؛ إذ يظهر على أنه حضارة متخلفة غير متطورة. (ص: 269).
ليختم فصول كتابه بالتعليق على المخاوف الغربية، متى أصبح المسلمون في الغرب أغلبية؟. مشيرا إلى الحماية التي يكفلها الإسلام للأقليات، وإثبات أو وضع الأقليات في الإسلام، وما تتمتع به هذه الأقليات من حماية وحقوق، ليبين بالفعل أن الإسلام أكثر النظم التي عرفها العالم إلى يومنا هذا ليبرالية.
وقد عرج هوفمان على الوضع الذي تعيشه الأقليات المسلمة بالغرب، المتسم بالتضييق والتهميش. ليتساءل فمن يجب أن يخشى الآخر إذاً؟. (ص: 337).
لقد حاول هوفمان في كتابه القيم والممتع، الدال على عمق معرفته بالدين الإسلامي، التدليل على قدرة الإسلام للانتصاب كأحد الخيارات والحلول الناجعة لأزمة العالم المعاصر. وهي محاولة تنضاف إلى مجموعة أصوات غربية تعتبر الإسلام المنقذ للإنسانية من هوة التوحش المادي الذي عيشه. وفي هذا الصدد يقول العالم الإسباني فلاسبازا: “إن جميع اكتشافات الغرب العجيبة، ليست جديرة بكفكفة دمعة واحدة، ولا خلق ابتسامة واحدة، وليس أجدر من أمم الشرق المحتفظة بالثقافة العربية –الإسلامية، والقائمة على إذاعتها بوضع حد نهائي لتدهور الغرب المشؤوم الذي تجر الإنسانية إلى هوة التوحش والتسلط المادي الاقتصادي”[11].
وإلى نفس الاستنتاج ذهب “جيم موران”، عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي حيث قال عام 1996م: “أعتقد أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن الإسلام وقرن الثقافة الإسلامية وستكون هناك فرصة لإحلال مزيد من السلام والرفاهية في كل بقاع العالم”[12]. أما “مرماديوك باكتول” فيقول: “إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها، حين قاموا بدورهم الأول؛ لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام حضارتهم”[13].
وسيكون من المفيد جدا أن نتوقف قليلا عند فيلسوف كبير حي، نقله حواره المتجرد العميق للحضارات من أغلاق الأرض إلى أعماق السماء … إنه “روجيه كارودي” الذي أصبح اليوم “رجاء الله كارودي” : لقد ظهر كتابه: “حوار الحضارات” في عام 1977م، وكتابه: “كيف تحققت إنسانية الإنسان”، عام 1979م، وكتابه: “نداء إلى الأحياء”، عام 1980م، وقد جعله بمثابة البيان الانتخابي لما رشح نفسه لرئاسة الجمهورية الفرنسية مع ديستان وميثران وشيراك، وقد أعقبه كتاب جعل عنوانه: “ما يزال في الوقت متسع لإنقاذ البشرية” … وقد أكد في بحوثه أن الحضارة المادية المعاصرة شرقية وغربية، أوربية وأمريكية، لم تنجح في وقف الحروب، وكف الطغيان، وتحرير الشعوب، وإطعام ومعالجة مئات الملايين من الجياع والمرضى والمشردين ومحو الأمية من ربع البشرية … بل إنها لم توفق في أكثر البلدان الموغلة في التقدم إلى حماية الإنسان من تسلط الإنسان، وصيانة الكرامة الآدمية، والحفاظ على القيم الدينية والروحية والأخلاقية والجمالية التي تعطي الحياة معناها الحق، وبهجتها وقدرتها على الإبداع …
لقد بدأ كارودي ماركسيا ملحدا، وكان يتبوأ مقام القيادة والزعامة في الحزب الشيوعي الفرنسي … ودعا في محاضرات له في القاهرة وسواها إلى أن تخصب الماركسية فلسفتها بعطاء الأديان عامة، والإسلام بخاصة، وإلا تكون قد حكمت على نفسها بالعقم … وعرضه ذلك إلى مشكلات وأزمات وألفوا ضده كتبا منها: “فلسفة الردة”، الذي طبعت ترجمته دار الطليعة في دمشق. ولكنه استمر في بحثه عن الحقيقة ودرسه الإسلام، فانكشف لبصيرته قيمه الباهرة، وقدرته الفذة على تلبية كل التطلعات الإنسانية السوية، ووجد فيه نظاما محكما، شاملا، عرفانيا، اجتماعيا، تربويا، اقتصاديا، أخلاقيا، روحيا … جديرا بإنقاذ الإنسانية من البؤس واليأس والهلاك قبل فوات الأوان …وهكذا قاده قلبه المستنير وعقله البصير، إلى اعتناق الإسلام وألف كتابه الجيد: “وعود الإسلام”، وقد أبدع في نقد الحضارة الغربية إبداع عالم مكابد، كما درس الإسلام بوصفه نظاما عالميا اجتماعيا اقتصاديا … له قيمه الروحية الهادية. وهو اليوم يدعو دون هوادة إلى إقامة حضارة “الإرث الثالث” ويقصد به الإسلام الذي يتوسط بين حضارة الأقوياء (العالم المتقدم) وحضارة الضعفاء (العالم المتخلف) كما يسمونه، ويرى أن حضارة الإسلام هي التي تصلح لإرث الأرض، لأنها توطد عقيدة التوحيد، وتوفق بين الإيمان والعلم، ولا تقيم حاجزا ولا وسيطا بين العبد وربه وتحفظ كرامة الإنسان وما يحققها من العدل والحرية والشورى…”[14].
إجمالا، إن هتافات كثيرة من هنا ومن هناك، تنبعث من القلوب الحائرة وترتفع من الحناجر المتعبة … تهتف بمنقذ و”مخلص”، وتتصور لهذا المخلص سمات وملامح معينة تطلبها فيه … وهذه السمات والملامح المعينة لا تنطبق على أحد إلا على الدين الإسلامي، على حد قول أحد الإصلاحيين المعاصرين.
إلى هذا الحد فإن من يخالفنا في هذا الرأي قليل، بالنظر لما أوردناه من شواهد غربية مطلعة. لكن ما يلبث أن يواجهنا أخطر إشكال يعترض سبيل كل باحث ساع إلى التدليل على أحقية الإسلام للانتصاب كحـل وحيد لأزمات العالم، ذلك هو إشكال: الكيف؟. فكيف يصبح للإسلام الدور الريادي في العالم؟ هل لدى المسلمين ما يؤشر على أنه سيكون للإسلام دور في إنقاذ البشرية؟ هل يستقيم ما قلناه من أحقية الإسلام للانتصاب كحل لأزمة العالم وحال المسلمين الأكثر تخلفا بين شعوب المعمورة؟ هل المعمول في إنقاذ البشرية على “إسلام” الحركات الإسلامية المعاصرة؟ هل جاءت الحركات الإسلامية المعاصرة بحلول جديدة لمشاكل العالم الإسلامي في إطار مقولة “الإسلام هو الحل”؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شعار تكرر رفعه منذ عصر النهضة؟. الأجوبة مفتوحة على اجتهادات أهل النظر والاجتهاد، والله الموفق.
الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]-مراد هوفمان، الإسلام في الألفية الثالثة: ديانة في صعود، تعريب، عادل المعلم، يس إبراهيم، مكتبة العبيكان، الرياض، ط، الأولى، 1424هـ/2003م.
[2]–ازداد هوفمان سنة 1931م، في اشافنبورغ، بلدة كبيرة في شمال غرب بافاريا بألمانيا، له العديد من الكتب التي تتناول مستقبل الإسلام في إطار الحضارة الغربية وأوروبا، وكان كاثوليكي المولد، واعتنق الإسلام سنة 1980م. عمل خبيرا في مجال الدفاع النووي في وزارة الخارجية الألمانية. وكان إسلامه موضع نقاش بسبب منصبه الرفيع في الحكومة الألمانية، وعمل كمدير لقسم المعلومات في حلف الناتو ثم سفيرا لألمانيا في الجزائر ثم سفيرا في المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1990م، و1994م.
كان باكورة أعماله: “الإسلام كبديل”، ثم كتاب: ” الإسلام في الألفية الثالثة: ديانة في صعود”، ثم كتاب: “رحلة إلى مكة”، يركز في العديد من كتبه ومقالاته على مكانة الإسلام في الغرب، وكان من الموقعين على: “الكلمة المشتركة بيننا وبينكم”، وهي رسالة مفتوحة من قبل العلماء المسلمين إلى الزعماء المسيحيين، تدعو إلى السلام والتفهم، عقب اعتداءات نيويورك وواشنطن.
[3]– علي حرب، مسألة الحرية، مساحة اللعبة وازدواج الكينونة، عالم الفكر، م33، ع4، يناير–مارس 2005م، هامش رقم 1، ص19.
[4]– هانزكينغ، نحو أخلاق عالمية، إعلان عالمي صادر عام 1993م، مجلة التسامح، مسقط، ع7، السنة الثانية، 1425هـ، 2004م، ص 58وما بعدها.
[5] – حسن السعيد، حضارة الأزمة ماذا قبل الانهيار؟، دار الهادي، بيروت، ط، الأولى، 2005م، ص5.
[6]– كان الفيلسوف الألماني “أزولد شبنكلر” من أوائل من أطلق صيحات الإنذار تلك بشكل جدي منذ ألّف كتابه الشهير: “تدهور الغرب”، أما “ألدوس هيكلسي”، صاحب كتاب الوسائل والغايات، فقد أخرج عام 1959م، كتابه: “العودة إلى عالم جديد جريء”، وقال فيه: “الإنسان في عصرنا لم يعد يستهلك الأشياء، بل هي التي تستهلكه”..ويذكر كيف أن الإنسان أصبح عبدا لعمله، فانحدرت قيمته الإنسانية، وعاش في أجواء القلق الذي يدعوه “هيجلي” ب “شقاء الضمير”.. وهناك كتب كثيرة عالجت هذا الموضوع، من أبرزها رواية “الأماكن المسمومة”، لـ “وليم سارويان”، و “الغزو المجهول”، لـ “ميشيل رونالد”، و “أوربا بعد المطر”، لـ “آلان بوزنس”، ولعل الفرنسي “إلكسيس كاريل” من أصرح وأصلح من عالج الموضوع، بعمق وصدق، ولا سيما في كتابه الفذ “الإنسان..ذلك المجهول”، الذي تزداد قيمته الأخلاقية والعلمية كلما ازدادت البشرية مكابدة وتلظيا بويلات تسلط الحضارة المادية الصناعية على الوجود…يقول كاريل: “إن الحضارة المعاصرة لا تلائم الإنسان كإنسان…وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير صالحة…إننا قوم تعساء لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا..إن الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة ذروة النمو والتقدم ، هي الآخذة في الضعف، والتي ستكون عودتها إلى الهمجية والوحشية أسرع من سواها..”. ومن أشهر السياسيين الذين عبروا عن خطورة الأزمة التي تعيشها الحضارة المعاصرة، نذكر الرئيس الفرنسي: شارل ديغول، حيث يقول: “إن مجتمعاتنا الأوربية فقدت شيئا ثمينا جدا تحت وطأة تقدمها الضخم، ألا وهو “الإنسانية” وأعني بها: القيم الروحية البشرية العليا، فقد قطعت حضارتنا تلك الصلة المعنوية التي تربط البشر بعضهم ببعض، لقد جف شعورنا، وتجمدت قيمنا الأخلاقية وانحلت”.
وأما نيكسون فل يتحرج عن أن يعلن في أول خطاب رسمي له بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية: “إننا نجد أنفسنا أثرياء في البضائع، لكن ممزقين في الروح؛ ونصل بدقة رائعة إلى القمر، وأما على الأرض فنتخبط في متاهات ومتاعب كبيرة”. انظر، عمر بهاء الدين الأميري، الإسلام وأزمة الحضارة الإنسانية المعاصرة في ضوء الفقه الحضاري، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض، ط، الأولى، 1414هـ/1993م، 17-19.
[7]– سيد قطب، المستقبل لهذا الدين، دار الشروق، القاهرة، طبعة 1411هـ/1991م، ص77.
-مراد هوفمان، الإسلام كبديل، ترجمة محمد غريب، قسم الترجمة، مؤسسة بافاريا، بيروت، ط، الأولى، 1993م.[8]
[9] – نفسه، ص 19-20.
[10] -نفسه، ص 20.
[11] – انظر، عمر بهاء الدين الأميري، م.س، ص20.
[12] – نقلا عن، حسن السعيد، حضارة الأزمة ماذا بعد الانهيار؟، م.س، ص283.
[13] – نفسه، ص282.
[14] – عمر بهاء الدين الأميري، م.س، ص 20-22.



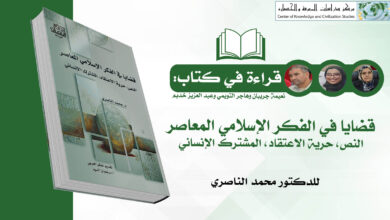

التعليقات